|
مصائر المخطوطات بعد رحيل الكتّاب والكاتبات!!
بقلم : إبراهيم نصر الله ... 24.04.2025 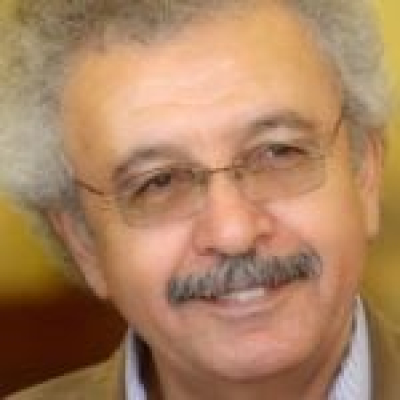
أشرتُ منذ شهور، إنه من الجميل أن يعثر المرء على نصوصه الأولى التي كتبها، وذلك بعد أن عثرت على (روايتين) لي، كتبتُ الأولى في العام الأخير من ستينيات القرن الماضي، والثانية بعد ثلاث سنوات من كتابة الأولى، وكانت بعنوان «المُلتقى».
تقع هذه الرواية في 80 صفحة، وكُتبتْ على دفتر من تلك الدّفاتر التي كانت توزِّعها علينا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في ذلك الزمان الذي كنت فيه منشغلاً بكتابة الشعر والرواية معاً، وإذا كان من شيء يدعو للإشارة إلى هذه التجارب، فهو ليس المستوى الفني لهاتين الروايتين، بل السؤال الذي يطرحه المرء على نفسه، وهو كيف استطاع ذلك الفتى، الذي يعيش سنوات مراهقته، أن يملك الصبر الكافي لأن يجلس ويكتب 80 صفحة بهذه المثابرة.
بالطبع، في الروايتين، هناك الرومانسية والأخطاء اللغوية المحتملة التي لا بدّ منها، ولكن النهايتين كانتا سعيدتين رغم قسوة ذلك الزمان.
في تلك الفترة كنت أستخدم اسم الأب والجد، إلى أن نشرتُ قصيدة في جريدة الدستور الأردنية في عام 1977، وظهرت باسم العائلة الذي لم أزل أستخدمه حتى اليوم.
الجميل في الأمر هنا أنني عثرتُ أيضاً على الكتابة الأولى لرواية «براري الحُمّى»، وتشير المخطوطة إلى أن تاريخها يعود إلى سنتين قبل صدور ديواني الأول «الخيول على مشارف المدينة، 1980».
وأقول «الجميل في الأمر»، لأنني أحسستُ أن هذا سيريحني من السؤال الذي تمّ توجيهه إليّ أكثر من مائة مرة! وهو: ما الذي دفعكَ للانتقال من كتابة الشِّعر إلى كتابة الرواية؟!
أمر المخطوطات كبير، ويطرح الكثير من القضايا نظرًا لما يحيط به من أسئلة، وإجابات ستظلّ ناقصة رغم بلاغتها في كثير من الحالات التي تتعلق بالكتّاب ومخطوطاتهم، فهناك دائماً ما يمكن أن ندعوه المُتفق عليه بهذا الشأن، وهناك المُختلف عليه، وصولاً إلى المرفوض.
نُشر ديوان محمود درويش الأخير «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي» بعد رحيله، ونُشر ديوان أمل دنقل «أوراق الغرف 8» بعد رحيله أيضًا، وهناك روايات وأعمال شعرية وكتب متنوعة ومذكرات نشرت بعد رحيل مؤلفيها، بعضها كان قد سُلِّم للناشر، وبعضها كان الكاتب قد أنهى العمل عليها، وبعضها اختلف الورثة فيه، وأعرف عددًا غير قليل من الكتّاب الذين تركوا مخطوطات مُنجزة، بعضها وصل المطبعة، لكن الورثة وقفوا في وجه نشرها، لأنهم رأوا أن فيها ما يمس الأسرة، أو يمس أشخاصًا، لذا ستتسبّب في مشكلات هم في غنى عنها، وهو إجراء نابع من ذاتية الأسرة التي حوّلت الكاتب من شخصية عامة إلى شخصية مملوكة للزوجة أو للأولاد أو قطاعات مريضة من المجتمع لا تقبل المساس بها.
لكن، في المقابل، هناك من قاموا بنشر أعمال كتّاب رحلوا، رافضين القرار الذاتي للكاتب بعدم النشر، لصالح الجانب العام الذي عبرت عنه مخطوطاته، وأبرزهم كافكا بالتأكيد، الذي أوصى صديقه ماكس برود بحرق مخطوطاته، لكن هذا الصديق تمرّد، ونشر هذه الأعمال، وحسناً فعل.
وعلى المستوى الآخر، نُشرت أعمال كان القرار بشأنها متأرجحًا، أو واضحًا، مثل الجزء الأخير من «البحث عن الزمن الضائع»، وقصائد لإيميلي ديكنسون، وستيج لارسون الذي رحل قبل صدور ثلاثيته «الفتاة ذات وشم التنين»، ونابكوف الذي نُشرت روايته «لاورا»، التي لم تكن مكتملة، وبالطبع غسان كنفاني الذي نُشرت له ثلاث روايات غير مكتملة: «برقوق نيسان»، و»الأعمى والأطرش» و»العاشق»، ورواية لم ينشرها في كتاب هي «من قتل ليلى الحايك».
ماركيز نُشرت روايته «موعد في آب» بعد رحيله أيضاً، وهي رواية كانت بين يديه طوال الوقت، ولم يرغب بنشرها، لكن الورثة عاكسوا رغبته ونشروها بعد عشرة أعوام من رحيله، ولا ندري إن كان الأمر نفسه قد حدث مع همنغواي الذي نُشرت روايته «جنة عدن» بعد 25 عاماً من رحيله أيضاً.
ربما يكون البرتغالي فرناندو بيسوا حالة فريدة جداً، إذ عُثر بعد وفاته عام 1935، على صندوق خشبي داخل غرفته يحتوي على أكثر من 25 ألف ورقة مخطوطة! من بينها قصائد، ونصوص نثرية، ويوميات، وأفكار فلسفية، وترجمات، وملاحظات مبعثرة، أغلبها غير منشور. بيسوا الذي كان ينشر في حياته بأسماء مستعارة؛ فهو عدة شعراء وكتّاب، ومن أسمائه: ألبرتو كاييرو، ريكاردو رييس، آلفارو دي كامبوس، وبرناردو سواريس، والأهم من هذا أن بينهم الشاعر الرومانسي والشاعر الغاضب والشاعر المتأمل.. إنه اتّحاد كتّاب في كاتب واحد.
لا يتسع المقال لذكر حالات كثيرة أخرى، ويستطيع المرء أن يجزم أن هناك مئات، إن لم يكن آلاف الحالات التي لم نسمع عنها في العالم، ويغيّبها ضعف الإعلام في أوطانها، أو تغيّبها أسرهم، إما بقراراتها الظالمة وإما بعدم إدراكها لما بين يديها من كتب قد تكون رائعة.
وأعود للبداية التي أثارها الحديث عن روايتَي في ذلك الزمان، فقد رأى صديقي الدكتور معجب الزهراني أن الأمر يتعلق بضرورة التوثيق من دون أن يشير إلى مسألة النشر، أما صديقي الشاعر صلاح أبو لاوي فقد كتب: «من المفيد أن تكون تلك المخطوطات وثائق تشير إلى البدايات، ولكن الخشية أن تطبع، بعد عمر طويل، فتسيء إلى التجربة، وهذا محطّ تساؤلات كثيرة ثارت عن وجوب الاحتفاظ بها أو تمزيقها». في حين تمنّى صديقي الروائي محمود شاهين أن يعثر على مخطوطات بداياته، كما كانت هناك آراء أخرى متباينة بهذا الشأن.
وبعــــد:
مسألة إخراج المخطوطات من عتمة الصناديق والدفاتر لكي ترى النور، ستظلّ تشغل المهتمين بالكتابة، مثل مسألة إعدامها، في وقت لا نستطيع فيه أن نكون جازمين بشأن الأهمية التي يوليها الدارسون لهذه المخطوطات عربيًّا، على الأقل، من دون أن ننفي أو نؤكد مدى هذه الأهمية التي أولتْها الدراسات والأبحاث لهذا الجانب في الحياة العربية الثقافية، التي تشهد أحياناً ظواهر رهيبة للتقليل من أهمية المُنجز المنشور، فما بالنا بالمخطوط المستور!
www.deyaralnagab.com

|