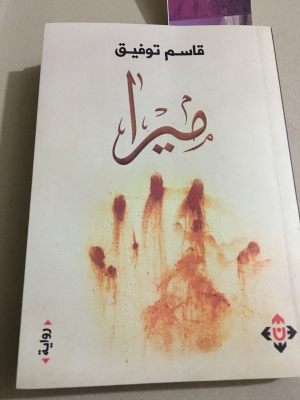في أحد أحياء إسطنبول، مشت امرأة تركية مسنّة بخطى أثقلها العمر، تحمل حقيبة قماشية وذكرى أبناء رحلوا في ليل ترك بصمته على قلبها. فقدت اثنين من أبنائها وصهرها خلال محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، لكنها اختارت أن تزرع حبًا.
وصلت إلى مدخل القصر الرئاسي، وتقدّمت بثبات الأمهات اللواتي لم يعد يخيفهن شيء. لم تطلب موعداً، ولم تنتظر واسطة، فقط قالت للحرس: «أريد مقابلة الرئيس، أحمل له شيئًا».
سمحوا لها بالدخول. في تلك اللحظة، لم تمثّل المرأة نفسها فقط، إنما حملت معها صدى أمهات كثر، من تركيا وفلسطين. وقفت أمام الرئيس رجب طيب أردوغان بعينين تختزلان سيرة حياة، وأخرجت من حقيبتها رزماً صغيرة من المال، لفتها داخل وشاح أبيض كأنها تهدي ورداً من قلبها.
قالت له بصوت خفيض، حاسم: «جمعت هذا المال على مدار سنوات. كنت أعدّه لشيخوختي، لكني رأيت أطفال فلسطين، حفاة، جياعاً، يطاردهم الخوف بدل الأحلام. لم أستطع الجلوس بصمت. خذ هذه المدخرات، وأعطها لهم… لا أريد شيئاً، فقط أن تصل.
حمل أردوغان الكيس الأبيض بيده، وتلقى الوصية، دون أن يقاطعها. لم تقف المرأة لتتلقى التصفيق، ولم تطلب صورة تذكارية. اكتفت بأن وضعت في يده رسالة صامتة من أمّ، أرادت أن تحوّل وجعها إلى دفء.
لم ترو هذه العجوز حكاية أبنائها، لم تذكر أسماءهم، ولا تفاصيل موتهم. لم تشتك، لكنها قدّمت ما تبقّى من عمرها على هيئة محبة. لم تحوّل الخسارة إلى مرارة، إنما أعادت تدويرها إلى نور.
الناس يركضون خلف الادخار، وهي أدركت أن المال لا ينقذ العمر… أدركت أن المعنى هو ما ينقذ.
حين قرّرت أن تمنح مدخراتها، لم تفعل ذلك من فائض، إنما من احتياجها نفسه… كانت تحتاج أن تشعر بأنها تنتمي إلى العالم، بأن ألمها لا يضيع، بأن أبناءها لم يغيبوا عبثاً.
لم تختر فلسطين صدفة. هي رأت وجهها في وجوه الأطفال هناك.
هي، مثلهم، فقدت الأمان. هي، مثلهم، عرفت معنى أن ينهار البيت على قلب الأم.
لم تكن علاقتها بفلسطين سياسية ولا موسمية. كانت علاقة أمومة… خيط إنساني يتجاوز الجغرافيا.
أرادت أن تطبطب على رؤوس الأطفال هناك، وأدركت أن يدها لا تستطيع أن تصل، فبعثت بقلبها.
حين خرجت من القصر، لم تنظر خلفها. لم تسأل إن كانت القنوات صوّرتها، أو إن كان أحدهم سيذكر اسمها. مشت كما تمشي الجدّات، ببطء مطمئن، كأنها أتمّت مهمّتها الأخيرة في الحياة.
ربما جلست بعد أيام في ركن بيتها الصغير، تنظر من النافذة، وتشرب الشاي، وتشعر براحة نادرة.
لم تتغيّر حياتها ظاهرياً، لكن قلبها صار أكثر خفة.
في وقت لاحق، أكل طفل فلسطيني وجبة دافئة، حملت في طيّاتها حنان تلك العجوز.
ربما لم يعرف الطفل من أين جاءت الوجبة، لكن الدفء الذي شعر به، حمل بصمتها.
في زمن يتحدّث فيه الجميع عن القضايا، كانت تلك المرأة الوحيدة التي تصرّفت حسب ضميرها ومبادئها.
يا عجوز الأناضول، تركت المال، وأخذت القلوب. أعطيت أكثر مما امتلكت. بين تركيا وفلسطين، خلقت جسراً من وشاح أبيض.
الضاحكة على عظام الجوع
كانت تضحك. في مشهد بدا مأخوذاً من رواية سوداء، تضحك امرأة ترتدي الزي العسكري، وتمثل بجسدها صورة من المفترض أن تثير الخوف، لكنها هذه المرة أثارت الغثيان.
ضربت الأرض بعصا، وتمايلت كأنها تحاكي طفلاً فقد القدرة على المشي… طفلاً شلّه الجوع، أو كسرت صمته قذيفة. ضحكت كما لا يضحك البشر.
ضحكت في زمن تتعفّن فيه الأجساد في الأزقة، وتنتظر الأمهات وجبات لا تصل، وتتوسل الأطفال فتات الخبز من الهواء.
أمام الكاميرا، قدمت عرضاً لا يحتاج إلى ترجمة، مشهداً يختصر بوقاحته وجهاً آخر للاحتلال: وجها يجيد السخرية من الموت.
في الركن الآخر من أركان غزة المعذبة، وقف صبي في السابعة، لا يعرف معنى العار، لكنّه شعر به. رأى وجهها، وسمع ضحكتها، ولم يفهم. لماذا تسخر منه؟
لماذا تتمايل وكأن جسده الهزيل مادة للتهريج؟ ما الذي أضحكها؟ الجوع الذي خر ساقيه؟ أم الارتعاش الذي يسكن جلده منذ شهور؟
لم يسألها، لكن سؤاله بقي معلقاً في الهواء، مثل رائحة الجثث التي لم تدفن.
جندية فقدت إنسانيتها بالكامل…
لقد علمها نظامها كيف تضحك على وجع العدو، كيف تحوّل الطفل إلى مادة للسخرية، كيف تخلع قلبها وتلبس زيّها العسكري درعاً ضد الرحمة.
لكن الأرض لا تنسى.
والضحكة، وإن بدت عالية، لا تغلب الوجع.
على بعد كيلومترات من ساحة سخريتها، حملت أم طفلها الذي لم يتحرك منذ يومين.
لم تملك له دواء، ولم تجد له طعاماً… جلست قربه متجمدة. ففي زمن القصف والجوع، لم يعد البكاء ترفًا.
رأت الفيديو، تلك الأم، أو ربما لم تره… لكن ضحكة الجندية وصلت إليها بطريقة ما.
وصلت عبر عيون الصغير، عبر رجفة في صدره المنمنم، عبر تنهيدة قالتها ولم يسمعها أحد.
أي لغة تلك التي تتيح لجندية أن تضحك فوق الركام؟ أي عقيدة تلك التي تربي جندياً على محاكاة الجوع كما لو كان رقصة؟ أي قلب ذاك الذي لا يرتعش أمام طفل يتضور؟
في كل لحظة كانت الجندية تتمايل وتقهقه، ماتت فكرة من ضمير العالم.
كل قهقهة لها كانت صفعة على وجه العدالة. كل حركة من عصاها كانت إهانة لأم لا تعرف كيف تسكت صراخ بطن صغير.
في لحظة واحدة، أسقطت تلك الجندية قناعاً آخر عن وجه الاحتلال: الاحتلال الذي لا يكتفي بالقتل، بل يسخر من وجع القتيل.
أين العدالة؟ أين الرد؟
هل يعاقب أحد على الضحك فوق جراح الآخرين؟
ربما لا. لكن التاريخ يسجّل. وكما سجّل أسماء من عذّبوا، ومن قتلوا، ومن دمّروا، سيسجّل من سخر. لأن السخرية من الجرح، أقبح من الجرح نفسه. اليوم، العالم يتحدث عن القصف، عن السياسة، عن الخرائط.
لكن أحداً لم يقف أمام ضحكة الجندية طويلاً.
لم يقل أحد: «كيف وصلنا إلى هنا؟»
لم يعلّم أحد تلك الجندية أن الوجع لا يهزأ منه.
لم يقل لها أحد: «هؤلاء بشر… حتى وإن ولدوا في خيام، حتى وإن شربوا الماء من الطين، لا يصبحون مادّة للضحك».
ما الذي ستفعله تلك الجندية حين تشاهد نفسها بعد أعوام؟
ربما ستكمل حياتها، وربما لن تتذكّر شيئًا.
لكن الطفل… الطفل الذي شاهدها يهزأ منه، لن ينسى.
فالعار لا يحتاج إلى صوت مرتفع كي يعلن عن نفسه.
يكفي أن نشاهد مشهداً كهذا، لنفهم أن الاحتلال لم يدمّر فقط البيوت، بل شوه الأخلاق. وفي زمن صارت فيه الضحكة سلاحاً، وقف الأطفال بأجسادهم النحيلة، يدافعون عن كرامتهم بالصمت.
أيتها الجندية، ضحكتك لم تكسر طفلاً، إنما فضحت أمة. ضحكتك ليست مزحة… هي جريمة أخلاقية. وحين تنامين الليلة على سريرك الدافئ، فكّري… هل تشعرين بالراحة؟
أما نحن، فحفظنا الموقف، وسنرويه لأبنائنا كي لا يولد جندي آخر ويظن أن السخرية من الجوع بطولة.
*كاتبة لبنانية